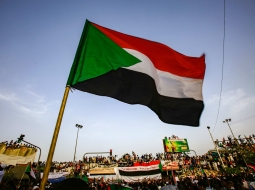د. عطية عدلان - الجزيرة مباشر
لولا الإسلام وما بقي معه من آثار الرسالات ما عرفت أوربا شيئًا عن حقوق الإنسان ولا عن الإنسانية، وإذا كان الخطاب الديني قد خَفَتَ صوتُه وخَفِيَ أثرُه؛ فإنّ الحقيقة تكمن فيما عبَّر عنه “بيغوفيتش” بقوله: “إنّ دفءَ الليلةِ سببُه شمسُ النهار السابق”، ولولا ما قرره القرآن في ضمير البشرية بهذا الإعلان العليّ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (الحجرات: 13)، لولا ذلك ما اشتمل الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان في مادته الأولى على هذا النصّ الرائع: “يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وُهِبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء”.
والحقُّ يقال: إنّ الثورة الفرنسية كان لها حظٌّ وافر من الإعداد الفكريّ لهذا الإعلان، بل إنّ إعلان الحقوق الذي أصدرته هذه الثورة كان هو الأصل الأول لكل ما جاء بعده من إعلانات حقوقية على الإطلاق، لكنّ ما حدث هو أنّ الثورة المضادة التي وُلِدت قبل انتصار واستقرار الثورة كانت -على الرغم من زحفها بعنف في الميدان العمليّ- كانت فكرية في الجانب الأكبر منها، لذلك لا نتعجب عندما يقرر “هارولد لاسكي” أنّنا من لدن الثورة إلى اليوم نقاوم الثورة المضادة، وعندما يقول “فرانسوا فورييه”: “إنّ تاريخ القرن التاسع عشر كله كان تاريخ الصراع بين الثورة والارتداد عليها”.
وإذا كانت فرنسا قد نالت شرف الريادة في الثورة على الموروث غير الإنسانيّ؛ فإنّها كذلك قد تصدرت الثورة المضادة التي حملت فوق ثبجها الهائج كل معاني الإمبريالية والعنصرية والعدوان الهمجيّ، هذه الازدواجية العجيبة سَجَّلها المؤرخ الكبير “فيشر” عندما قال: “أضف إلى ذلك أن الجمهورية كانت حكومةَ فتحٍ ودعاية، فإنَّ رغبتها الشديدة في فرض عقيدة سياسية على العالم، وضرورات خزانتها الخاوية؛ اتحدت على دفعها إلى سلوك طريق لعبت فيه دورا مزدوجًا: دور المبشر برسالة، ودور اللص المغتصب”، لذلك لا نتعجب إذا رأينا فرنسا تنطلق بعد ثورتها وقد سابقت جحافلها الاستعمارية أصداء ثورتها المباركة التي تنادي بحرية الإنسان، جنس الإنسان! ولا نندهش إذا رأيناهم يخرقون كل تعاليم الثورة ويدهسون الإنسان دهسًا في الجزائر وغيرها من المستعمرات الفرنسية في إفريقيا!
“لقد كانت حملتنا تدميرًا منظَّمًا أكثر منها عملًا عسكريًّا، كم من أوقات مضيناها في حرق القرى والأكواخ… آه أيتها الحرب؛ كم من نساء وأطفال تجمعوا فوق جبال أطلس العالية التي تغشاها الثلوج؛ ليموتوا هناك من البرد والجوع”، كلمات نقلها كتاب “جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر” عن أحد الجنود الذين شاركوا في العدوان. ومع ذلك، وعلى الرغم من كل تلك الجرائم التي ارتُكبت هناك من قتل جماعيّ وتعذيب وحشيّ واغتصاب جنونيّ؛ وجدنا الشاعر والأديب الكبير “فيكتور هوغو” -حسبما نقل سعدي بزيان- يصف ما جرى في الجزائر على هذا النحو المخزي: “إنّها الحضارة تكتسح البربريّة، إنّه الشعب المستنير يذهب باتجاه الغارقين في الظلام؛ نحن إغريق العالم وعلينا أنْ نُضيئَه”.
وإِذَنْ فهي العقدة الفكرية والتصورية والشعورية لدى الغرب عمومًا وفرنسا خصوصًا، عقدة الشعور بالتميّز والتفوق المتمركز بصورة دائمة في الجنس الأوربيّ الأبيض، هذه العقدة لم تُترك هكذا متجردة حتى اختلطت وامتزجت بالمزاج الغربيّ الذي لا يفارقه الطمع والأنانية والنزعة العدوانية، ومن هذه العقدة وما خالطها من المزيج النكد نشأت الأدواء التي لا يوجد لها على الأرض دواء، وعلى رأسها داء العنصريّة؛ فمن الطبيعيّ إذَنْ أن نرى آثار هذه العنصريّة متجلية في التصرفات اليوميّة اتجاه اللاجئين والمهاجرين، ولا سيما الأفارقة والمسلمين، ومع تصاعد المدّ اليمينيّ تتصاعد الظواهر المنعكسة عن داء العنصرية، وربما كانت الأمم المتحدة تدرك أنّ فرنسا تحديدًا غارقةٌ في هذا المستنقع؛ عندما أصدرت بيانها الأخير.
بعدما أبدت الأمم المتحدة قلقها اتجاه الأحداث التي اجتاحت فرنسا في الأيام الأخيرة بسبب مقتل الشاب “نائل” على يد قوات الأمن الفرنسية؛ دَعَتْ الحكومةَ الفرنسية إلى معالجة العنصرية التي تُمَارس عند إنفاذ القانون، لكنّ الحكومة بدلًا من بحث المشكلة الأصلية التي يعاني منها المهاجرون -ولاسيما الجزائريين- راحت تبحث في مشكلة ضواحي باريس كأزمة أمنيّة؛ لكونها تشتمل على المهاجرين؛ إنّها النفسيّة الفرنسية التي لا تريد أن تبرأ، ولقد جسّد السفير الفرنسيّ لدى أمريكا المزاج الفرنسي العام في حديثه لنيويورك تايمز، حيث قال: “من السهل التعامل مع ملف المهاجرين إذا كانوا من الكاثوليك البيض، أمّا عندما يكونون أفارقة أو مسلمين فإنّ ذلك يجعلنا نصل إلى طرق موصدة”.
إنّ أزمة الضواحي هذه قبل أن تكون أزمة أمنيّة هي أزمة عنصرية، وصورة من صور التهميش لكل المجنسين الذين ينحدرون من أصول غير لاتينية، ولقد أشار “الرئيس أردوغان” في كتابه “نحو عالم أكثر عدلًا” إلى هذه المشكلة بقوله: “إن الأتراك مهمشون في ألمانيا، وكذلك المغاربة في فرنسا، واللاتين في أمريكا، والسود في جميع أنحاء العالم”، ولطالما ردّت تركيا على تصريحات فرنسا المناهضة لسياستها بالقول: على فرنسا ألا تنسى أنّها آخر دولة يمكنها أن تتحدث عن حقوق الإنسان.
لا يمكن النظر إلى المهاجرين على أنّهم منبوذون إلا في إطار فكر لا علاقة له بحضارة ولا مدنية، بل لا علاقة له بالواقع الذي يعيشه أكبر بلدان العالم حضارة، وكم كان “إيرك هوفر” دقيقًا عندما قال: “إنّ المنبوذين في بلاد أوربا هم الذين عبروا المحيط لبناء عالم جديد في القارة الأمريكية”، فليس عند المهاجرين ذنبٌ، إنّما الذنب عند من قال فيهم “هوفمان”: “وما زالت الحاجة ماسة لأن تؤلف زجريد هونكة كُتُبًا مثل (الله ليس كذلك)؛ لتزيلَ عن كثيرٍ من الأوربيين عُقَدَهم الاستعلائية اتجاه العالَمَيْن العربيِّ والإسلاميّ”.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مواضيع أخرى للكاتب
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس